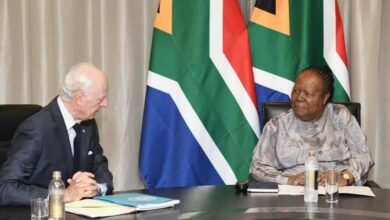البيجيدي لم ينهزم بل كما جيء به تم الاستغناء عنه..قراءة فيما سمي ب” الهزيمة المدوية”
يفيدنا تاريخ الاسلام السياسي بالمغرب أن أغلب أعضاء وقياديي حزب العدالة والتنمية، وذروعه الدعوية، نشأ وترعرع تحت أعين النظام المغربي، منذ توظيفهم كحركات اسلامية شبيبية ودعوية ضد كل أطياف اليسار في اواسط الستينات وما بعد، في المؤسسات التعليمية الثانوية ثم الجامعة والشارع العام. وكلما ازداد اليسار نموا وامتدادا، زادت عملية التوظيف والسماح للاسلاميين بتطوير أساليب ترهيبهم لليسار، وصلت إلى حد الاعتداءات الجسدية والاغتيالات.( مثال عمر بنجلون وبنعيسى آيت الجيد…الخ).

وبعدما تقوت حركة المطالبة بالاصلاحات السياسية والدستورية التي تبنتها الكتلة الديموقراطية في 1992، والتي جمعت كلا من الاتحاد الاشتراكي، ومنظمة العمل الديموقراطي الشعبي، وحزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال….بعد هذا، استدعى ادريس البصري، بواسطة اجهزته المخابراتية، هذه القيادات الاسلامية، وأعطاها الضوء الأخضر، لتشكيل حزب سياسي تحت قيادة واحد من خدام النظام السياسي الكبار وهو الراحل الدكتور الخطيب. ( للتعرف على علاقات الدكتور الخطيب العائلية وقراباته مع عائلات المخزن راجع كتاب أمير المومنين لوات بري. Waterbury John, Le Commandeur des croyants. La monarchie marocaine et son élite.) فكان حزب الحركة الشعبية الدستورية، الذي سيتحول إلى حزب العدالة والتنمية، وتحددت وطيفته الجديدة في مناهضة كل دعوة لأصلاحات دستورية، ولا سيما المتعلقة بمطلب الملكية البرلمانية.
ورغم تورط عدد من المحسوبين على هذا الحزب الجديد، في أحداث 16 ماي 2003، بعد أن احتل موقعا متقدما في انتخابات 2002، مستغلا الفراغ الذي خلفه الاتحاد الاشتراكي وسط قواعده الشعبية بسبب قيادته لحكومة ما يسمى بالتناوب. لم يلجأ النظام إلى حله، بل إلى تدجينه وترويضه ليكون بعد إدانته العلنية للارهاب والتطرف، أداة طيعة لخدمة النظام في مستقبل الأيام.

فحزب العدالة والتنمية، لم يندحر كما يروج له انطلاقا من هزيمته الأخيرة. فهو لم يأت للحكم عبر انتصار في صناديق الاقتراع كما توهم الجميع، بل جيئ من خلال هذه الصناديق، تبعا لإكراهات سياسية اقليمية ودولية، في ظرفية خاصة، اجتهد فيها النظام السياسي، بواسطة ” خبرائه ” المحليين والدوليين، لإبداع مخرج يحافظ على ” الاستثناء المغربي “. ويجنب البلد والنظام منطقة الزوابع والاعصارات.

كان الركوب على شعار ” اسقاط الفساد ” كافيا لملئ الفراغ الذي خلفة اليسار بجميع أطيافه، مما جعل الحزب الاسلامي، يحتل المرتبة الأولى بدعم من المطبخ السري، ثمنا للدور الذي لعبة في لجنة صياغة الدستور الجديد ويؤهله لقيادة أول حكومة مغربية برئيس يملك اختصاصات، لم تتوفر أبدا لأي رئيس وزراء سابق في تاريخ المغرب.
لقد كان من المنتظر، في تقديرات المطبخ السياسي، انتهاء صلاحية هذا الحزب، بعد ولايته الأولى، خاصة بعد إعطاء الضوء الأخضر للوافد الجديد (حزب الاصالة والمعاصرة)، كحزب نشأ على يد علي الهمة، وريث ادريس البصري في الداخلية، وترعرع برعايته، كي يتهيأ للولاية المقبلة، معتمدا على معارضة شباط ولشكر.

لكن ” الحساب خرج عوج ” وكان لسوء التقديرات من جهة، وخطاب المظلومية الذي تبنته قيادة حزب العدالة والتنمية والعزوف الانتخابي من جهة ثانية…كل هذا خلط الأوراق في استحقاقات 2015/2016، وسمح بتمديد صلاحية بنكيران “غير المرغوب” فيه، الشيء الذي نتج عنه مسلسل البلوكاج الذي انتهى بإقالة هذا الأخير، وتعويضه برئيس حكومة جديد، فاقد لكل مؤهلات رجل الدولة، من جهة، ومستعد للانبطاح لتوجيهات وتعليمات الدولة العميقة في جميع مجالات التدبير. الشيء الذي أدى خلال سنوات سوداء سياسيا إلى النتيجة الطبيعية التي كان معولا عليها في الاستحقاقات السابقة، بعد الولاية الأولى.
إن بنية نظامنا السياسي الحالي، لا تعتمد على التنافس الديموقراطي، كما هو منصوص عليه دستوريا. بقدر ما تقوم على الترتيب والتخطيط المسبقين للخرائط الانتخابية، من طرف الأجهزة التي سميت بالدولة العميقة، أو الحزب السري، أو التماسيح والعفاريت…الخ، هذا التخطيط الذي تهيأت له جميع الشروط، بحسابات دقيقة تستفيد من الأخطاء، كي يكون هو النتيجة التي تعلنها صناديق الأقتراع.

وهي نفس بنية النظام السياسي، التي جاءت بالاتحاد الاشتراكي بعد استحقاقات 1997 لقيادة ما سمي بحكومة التناوب التوافقي، كي يقدم خدمته بدون ضمانات دستورية، من أجل إنقاد المغرب من ” السكتة القلبية “، لتتم عملية إنهاء صلاحيته، والاستغناء عن خدماته، رغم صدارته لانتخابات 2002، لأن الدستور السابق لا يضمن استمرار رئاسته للوزراء، كما يضمن دستور 2011 رئاسة الحكومة للحزب المتصدر. مما دفع بتيار الاستوزار داخل الاتحاد الاشتراكي، الذي ذاق نعمة الكراسي، إلى التشبت بالمشاركة في حكومة جطو، رغم ” ركلة ” الخروج عن المنهجية الديموقراطية، التي ستركل هذا الحزب بكل زخمه التاريخ، ليصبح حزبا ذيليا وتابعا لمن عارضهم طيلة تاريخه.
 لم تكن نتائج استحقاقات 2021 إذن، اندحارا للعدالة والتنمية، ولا انتصارا لإيديولوجية زواج المال بالسلطة، ولكنها كانت تعبيرا واضحا، عن نجاح الدولة العميقة في التخطيط للخرائط السياسية، والتحكم في التدبير والتوجيه لمن يسمون ب ” الفاعلين ” الساسيين، الشيء الذي يجعل المغرب يعيش ما يسمى بالديموقراطية المتحكم فيها عن بعد ومن وراء حجاب. ديموقراطية بعيدة عن أي تنافس برامجي بين الاحزاب، أو استقلالية قرارها السياسي في التحالفات، بل حتى في تدبيرها للملفات الكبرى للبلد. وهو المنطق السياسي الذي استبطنه الجميع، أحزابا وفاعلين ومواطنين ومواطنات، بجميع شرائحهم، أغنياء وفقراء، متعلمين وأميين، علماء وجهلة، متحضرين ومشرملين مشمكرين، مشتغلين وعاطلين، متنورين وظلاميين،….الجميع اليوم يردد المبدء الذي يقود البلاد وهو
لم تكن نتائج استحقاقات 2021 إذن، اندحارا للعدالة والتنمية، ولا انتصارا لإيديولوجية زواج المال بالسلطة، ولكنها كانت تعبيرا واضحا، عن نجاح الدولة العميقة في التخطيط للخرائط السياسية، والتحكم في التدبير والتوجيه لمن يسمون ب ” الفاعلين ” الساسيين، الشيء الذي يجعل المغرب يعيش ما يسمى بالديموقراطية المتحكم فيها عن بعد ومن وراء حجاب. ديموقراطية بعيدة عن أي تنافس برامجي بين الاحزاب، أو استقلالية قرارها السياسي في التحالفات، بل حتى في تدبيرها للملفات الكبرى للبلد. وهو المنطق السياسي الذي استبطنه الجميع، أحزابا وفاعلين ومواطنين ومواطنات، بجميع شرائحهم، أغنياء وفقراء، متعلمين وأميين، علماء وجهلة، متحضرين ومشرملين مشمكرين، مشتغلين وعاطلين، متنورين وظلاميين،….الجميع اليوم يردد المبدء الذي يقود البلاد وهو
لي بغاها المخزن هي لي كاينة
وهذا ما يطرح سؤال:
ما الجدوى من الديموقراطية، وبالتالي ما الجدوى من الانتخابات وإهدار 150 مليار سنتيم عن نتائج تم تحضيرها في المختبر السياسي.