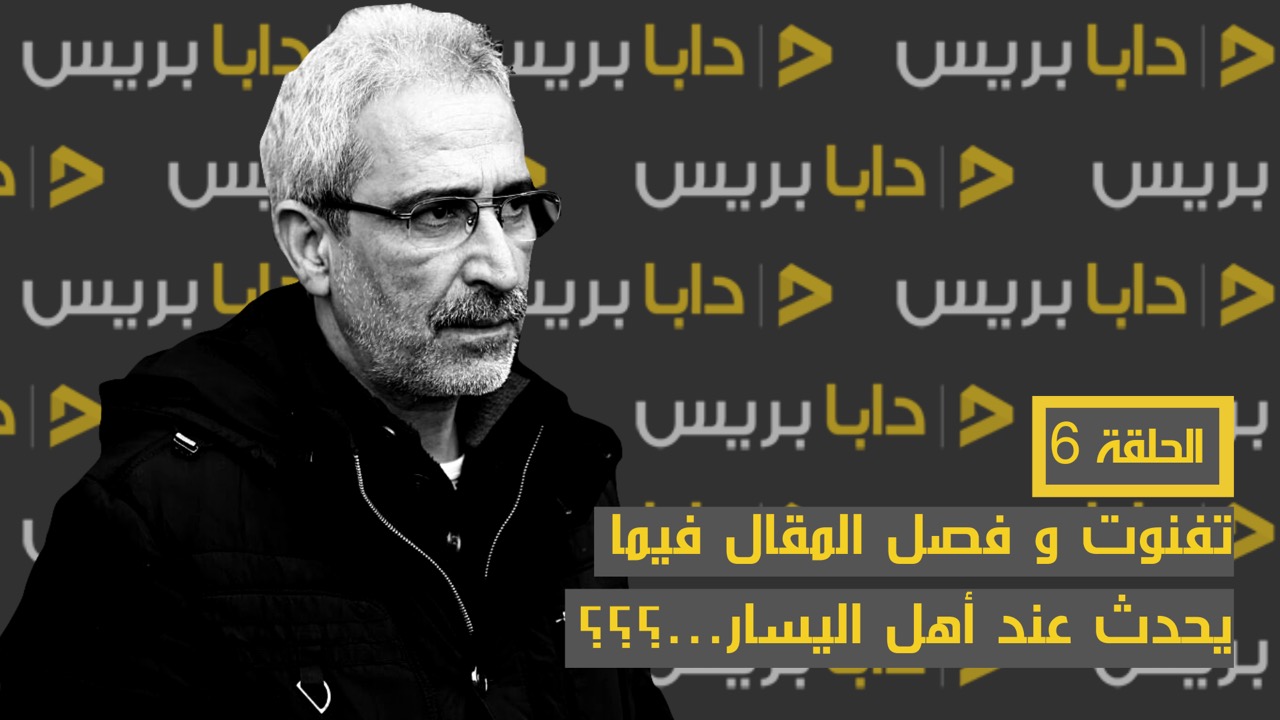
عند توقفنا في الحلقة السابقة على ما أسميته ب ظاهرة ” التماهي ” بين الذات الحزبية وذات الحركة الاحتجاجية الفبرايرية والتي سيطرت على أجواء النقاشات الداخلية للحزب الإشتراكي الموحد و على مسلسل تحضيراته لمؤتمره الثالث،لم يغب على ذهنناأن هذه الحالة لم تتوقف عليه لوحده كاستثناء، بل إن هذا الأمر قد شمل كل الفاعلين السياسيين من داخل المجتمع بأطيافه المتفاوتة، ومن داخل الدولة وعلى أطرافها جميعا…
لقد شكلت حركة الشارع العام وعلى طول الزمن الذي تظاهرت فيه وفي جميع المواقع الجغرافية في المدن والقرى هذفا للضبط والتحكم أو رهانا للإستيعاب، لدرجة أننا شاهدنا تسابقا غير مفهوم، حتى عند من نصب نفسه لمعاداتها وإسقاطها بدعوى الحفاظ على الإستقرار،لتبني شعاراتها وخطاباتها ونقدها الحاد والصريح لطبيعة الدولة وخياراتها…
كما جندت أحزاب ومجموعات محسوبة على جماعات الضغط الرسمية على مد جسور الإستقطاب لجذب شباب مؤثر وحامل لخطاب تصعيدي قصد إلحاقهم بصفوف شبيباتهم وبعض من جمعياتهم المستفيدة من الدعم العمومي أو الخارجي، حتى يباهون منافسيهم بأنهم استوعبوا أكثر من غيرهم عددا من أطر حركة عشرين فبراير، لا ليستفيدوا من وهجهم ” النقدي ” و” الثوري “،بل ليقدموا عربون ذكائهم لأجهزة الدولة أنهم ساعدوا على إضعاف هذه الحركة الإحتجاجية التي ” تخوف ” منها قسم كبير من النخبة المسيطرة على سياسة البلاد وثرواتها…

هذا إضافة إلى قوى أخرى نزلت بكل خزانها التعبوي كي تتملك شرعية التأثير على إيقاع نضالية الحركة والرفع من سقف مطالبها بطريقة غير مباشرة، تستعمل لغة معيارية تستبطن التمييز بين المنخرطين في الإحتجاج على أساس من هو الجذري أكثر من الآخرين، ومن هو المعبر عن آمال الشعب والجماهير الغاضبة أكثر من غيره…
صحيح أن ماميز القسم الكبير من مناضلي الإشتراكي الموحد ورفاقهم في مكونات الفيديرالية هو الإبتعاد عن خيارات الإستدراج الفج للحراك إلى وعاءاتهم التنظيمية، لكن هذا لم يعفي بعض قيادييهم في ارتكاب أخطاء سياسية خلقت ارتباكات في صفوف قوى اليسار الواسع في تعارض مع الإصرار السلطوي للدولة وأتباعها المساندين لخياراتها الإقتصادية الشرسة أو خياراتها الأوتوقراطية الدينية…

لقد وقع لحركة المطالب الجماهيرية التي حملت اسم يوم انطلاقها(20 فبراير 2011) لذلك الطفل اليتيم في الأساطير القديمة حيث ادعت كل الأقوام والأجناس والقبائل الفقيرة منها والغنية المحاربة والمهادنة أبوتها له وحقها في أن يحمل اسمها، لسبب وحيد هو أنه لايشبه أحدا فيهم، لانهم لم يعودوا ينجبون ويلدون…
في حين أن هذا الطفل اليتيم لم يكن يبحث عن سلطة أبوية، أو عمن يهبه إسمه، كان يريد فقط من يحميه ويعطيه الحق في الكلام والعيش الكريم…وأن يدخله إلى مدارس السابقين واللاحقين كي يتعلم الحروف الأولى من قاموس التفكير وفك الرموز المستعصية، في عالم صار فيه الجميع يبحث لمعتقداته عن سلطة تعوض لهم حكم الأرض والسماء، ومن عليها دون حسيب ولارقيب…
وفي هذا الباب يمكن القول وبصدق، أن الحزب الإشتراكي الموحد لم ينجح في مواجهة المرحلة الفبرايرية بتخطيط قيادي استراتيجي جوهره ومنطلقاته وأدواته تسكن في ” قارة ” السياسة لا في جزر اليوتوبيا ومدن العبارة المفوهة… وهذا الكلام لا يجب أن يفهم منه أنه كان حزبا بلا قيادة، ،فالقيادة كانت هناك في هذه اللحظات، وكانت تمارس دورها التنظيمي اليومي، بل وبشكل كثيف الحضور كان يستدعيه الظرف الصعب الذي دخله المغرب آنذاك…

لكن الذي كان ينقصها هو وجود تخطيط استراتيجي في وضع طارئ ، متعدد التأويلات، و كان مفتوحا على العديد من الإحتمالات كما هي الحالة عليه من المحيط إلى الخليج…والحال أن عمق الهزة كان يتطلب التغيير الذكي والسريع للعديد من العوائد النضالية الثقيلة التأثير، والإنطلاق إلى سرعة ذهنية وحركية متطورة…
لقد بقيت أغلب تيارات و أطراف اليسار تتصرف معزولة عن بعضها، موزعة بين فريقين ، فريق ينتظر أجندة الدولة وماذا ستفعل ،وفريق وضع أعينه على الشارع وسار يتفاعل مع وقائعه ميدانيا، ، وكلا الفريقين سار منذ البداية منفعلا لا فاعلا إلا من زاوية إصدار الموقف ردا على موقف آخر…







