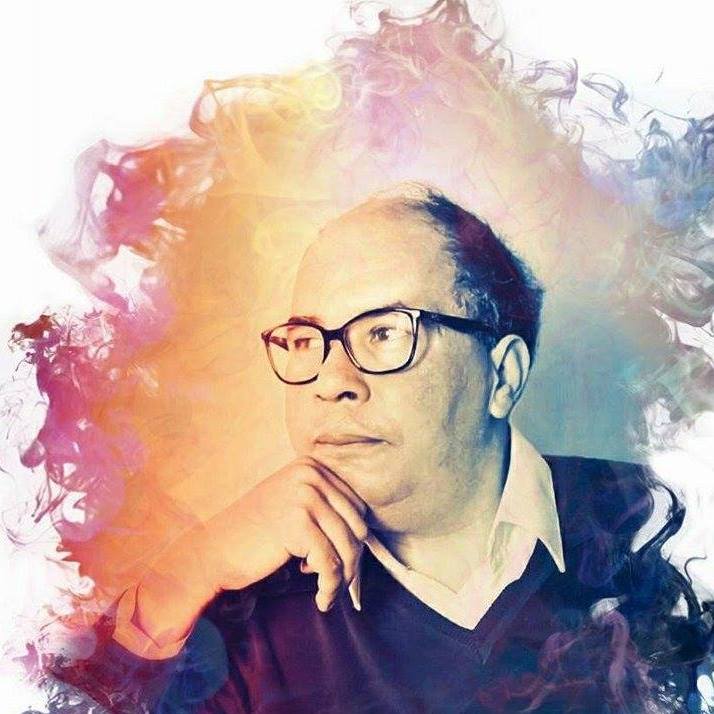
سعيد ناشيد يكتب لماذا نفشل في الحب؟!
لماذا نفشل في الحب؟!
تجارب الحب رائعة تلهم الكثيرين وتغري الجميع. لا شكّ في ذلك. غير أنّ معظم تجارب الحب لا تدوم طويلا. ينتهي أغلبها إلى الفشل عاجلاً أو آجلاً. كما لو أن الحبّ نار بعد أن تغلي الماء تخبو وتنطفئ. بل كثيراً ما تنطفئ قبل غليان الماء. ثمة قاعدة واضحة، عندما تكون نسبة النجاح ناذرة فمعناه أن التجربة غير مناسبة، أو أن هناك شيء غير مناسب داخل التجربة.
يطرح الحب إشكاليات شائكة، مثلا، إذا كان الحب ضمن المشاعر المبهجة حسب سبينوزا –ولا أحد ينكر ذلك- فلماذا نشعر بالحزن عندما نقع في الحب –والكل خبر ذلك-؟ عندما نشعر بالفرح والحزن معاً فمعناه أن هناك بكل بساطة ما يبرر الفرح، وهناك في المقابل ما يبرر الحزن أيضاً. إذا عرفنا ما يبرر الفرح ( المتعة، الشهوة، القبلة، العناق، الجنس، إلخ ) فما الذي يبرر الحزن إذاً؟ يقودنا التأمل إلى استنتاج أوّلي: مبرر الحزن أن تكون مشاعرنا أو مشاعر الطرف الآخر غير حقيقية. إنه الخوف من أن نكون إزاء عملية خداع لأنفسنا حتى في حالات الاعتقاد بأننا صادقون. أليس “الحب كذبتنا الصادقة” كما قال محمود درويش !؟
هكذا تحتمل تجربة الحب نوعا من القابلية للانخداع الذاتي، وهذا بصرف النظر عن النوايا. يكفي أن نتساءل كم مرّة اكتشفنا بأن شعورنا بالحب لم يكن عميقا كما ينبغي -بمعنى لم يكن صادقا- لكن فقط بعد أن تخلصنا من التجربة؟ هناك قابلية أصلية للانخداع هي التي تجعل الحب مدعاة للحزن. لذلك، يحفل الحب في التراث الشعري والغنائي الإنساني بالمفارقات الوجدانية الحارقة، فهو داء ودواء، فرح ودموع، جنة ونار، إلخ.
السؤال الأكثر إشكالية في الحب، حسب الفيلسوف والإعلامي البريطاني آلان دو بوتون، هو أيضا السؤال الأكثر بساطة: “لماذا هو بالضبط / لماذا هي بالضبط؟ ( عزاءات الفلسفة). هل يملك العشاق من إجابة عن السؤال سوى الرد برسالة فارغة أو تقول: “لا أعرف”.
الرهان أن نفهم. لكن ثمن الفهم أحياناً أن نخسر سحر الأشياء. مثلاً، لقد فهم الإنسان المعاصر معنى القمر، فهو مجرّد كتلة صخرية شاحبة وجرداء. لذلك لم يعد القمر يلهم الشعراء والعشاق كما كان في الأزمنة القديمة. أن نفهم معنى الحب، معناه أن نكشف سرّه، معناه في الأخير أننا قد نضحي بسحره. وهل يملك الحب غير سحره !؟ لذلك، حتى الفيلسوف الفرنسي آلان باديو الذي يعتبر مهمة الفلسفة اليوم الدفاع عن الحب في وجه المصلحة والتقنية ( في مدح الحب)، لم يجرؤ على إزاحة السحر عن هذا الحب، لم يجرؤ على الإجابة عن السؤال: ما الحب؟ بمعنى إذا ما سايرناه في تحليله فالنتيجة بكل بساطة أن على الفلسفة أن تدافع عن “سحر” لا تفسير له. لكن ألا يكون هذا الموقف تضحية بالفلسفة؟! ( التوضيح) عنوان كتاب هو مناظرة جمعت ألان باديو نفسه بألان فانكلكروت. لذلك ثمة حق فلسفي في توضيح ما الحب؟ فأين سنواصل البحث؟ كثيراً ما نعثر على الشيء حيث لا نتوقع العثور عليه. دعنا اختصاراً نفتش في حقيبة شوبنهاور.
يصنف ألان باديو شوبنهاور باعتباره الممثل الأوّل للفلسفة المعاديّة للحب ( في مدح الحب). توصيف ليس دقيقاً، بل ينم عن تأويل متجاوز. خلاف ذلك يعلمنا شوبنهاور قواعد السعادة العملية سواء بنحو صريح أو بنحو ضمني: بنحو صريح لأن ضمن مؤلفاته الأخيرة كتاب جميل بعنوان ( فن أن نكون سعداء)؛ وبنحو ضمني لأن التحرر من الأمل هو أيضا فرصة للتحرر من خيبة الأمل. إذا كنا نتعلم الكثير من قواعد السعادة من شوبنهاور الموصوف بالتشاؤم، فهل بوسعنا أن نتعلم منه الحب وهو الموصوف بكراهية النساء ! لنواصل البحث.
يقوم موقف شوبنهاور من الحب على الأساس التالي: في الحب لسنا نحن الذين نختار وفق ذوقنا الخاص كما نتوهم، لكن الطبيعة هي التي تختار الأنسب لها ولغاية نسل متناسب. لذلك قلما نرى، كما يشرح بوتون في ( عزاءات الفلسفة)، رجلا طويل القامة يعشق امرأة طويلة القامة، أو العكس، قلما نرى –بمزيد من التوضيح- رجلاً طويل الأنف أو أفطسه، جاحظ العينين أو غائرهما، يعشق امرأة بنفس الخصائص، أو العكس أيضا. ففي الأجندة الخفية للإغراء “يسعى الشخص من خلال الشخص المغرم به، إلى إلغاء نقاط ضعفه، وعيوبه، وتشوهاته عن الشكل النموذجي، لكي لا تتنامى وتصبح تشوهات كاملة عند الطفل الذي سيتم إنجابه” ( عزاءات الفلسفة). إذن لا سرّ في الحب ولا سحر سوى ضمان نسل متناسب، حتى ولو كان ذلك –كما هي معظم الحالات- على حساب سعادة الأزواج، والتي هي آخر ما يهمّ الطبيعة.
بعيداً عن التصور الرومانسي، تبقى الطبيعة ماكرة. مثلاً، زوجان في مقتبل العمر يمارسان الجنس يوميا، هذا ممتع، لكن الطبيعة التناسلية تخبئ لهما أجندة سرية، إذ تريدهما أن ينجبا عشرة أو عشرين، ومع مرور الأيام يأخذ حجم المتعة في التقلص. فيا للورطة ! هذا ما يجعل الكثيرين بعد فترة قصيرة من الزواج يشعرون كأنهم وقعوا في فخ ما. ولأنهم لا يجدون تفسيراً لهذا الفخ الغامض فقد يراه كل واحد في الطرف الآخر. وقد يصبح استمرار العلاقة مجرّد “تضحية” يمنّ بها أحدهما على الآخر، أو يمنّان بها على الأبناء ويا للبؤس !
لكن، لماذا تضطرّ الطبيعة إلى خداعنا؟ لأنها حسب شوبنهاور تدرك بأن الإنسان أعقل من أن يتكبد عناء التناسل عن طواعية فيما لو لم توجد غواية قوية إلى درجة تجعله يفقد عقله. لقد وُجد الحب لكي نفقد عقولنا. وهذا كل ما في الأمر.
والآن، بعد أن أزحنا السحر عن الحب ألا نكون قد ضحّينا به طالما ليس للحب غير سحره؟ الحبّ فخ بالفعل، لكنه فخ جذّاب، لا يمكن مقاومته بدون خسائر باهظة. فهل هناك من خيار آمن؟ الحرية بمعناها الهيجلي هي هامش انفلات الوعي من قبضة الضرورة الطبيعية. هنا تندرج إحدى الأبعاد الإستراتيجية للحداثة: تحرير الحبّ من الأجندة الخفية للطبيعية. وثمة معالم واعدة، من بينها أذكرُ ما يلي:
-أولا، ظهور وتطور موانع الحمل، والتي منحت للإنسان فرصة “التحايل” على الطبيعة، بحيث يأخذ منها المتعة التي تمنحه دون أن يدفع لها الثمن الذي تطلبه.
-ثانيا، الاعتراف بالزواج المثلي، والذي ليس مجرّد اعتراف بحق الجميع في الزواج بلا تمييز، بل اعتراف رسمي بمشروعية الحب المجرّد كليا عن كل أشكال الضرورة التناسلية.
-ثالثا، تطور ثقافة القُبلة العميقة كانزياح شبقي عن الضرورة التناسلية. إذ لا تمرّ القُبلة عبر الرعشة الجنسية، لذلك لا تنقطع نشوتها، إنها كحالة السكْر لدى شعراء التصوف. ههنا استنتاج لا يخلو من أهمية: قد يتحقق الجنس بلا حب، وهذا الأمر يعرفه الرجال أكثر. قد يتحقق التوالد بلا حب، وهذا الأمر يعرفه الرجال أكثر. لكن وحدها القُبلة العميقة تدلّ على الحب العميق، وهذا الأمر تعرفه النساء أكثر. تحرير الحب يعني تأنيثه. وقديما قال مولانا ابن عربي “المكان إذا لم يؤنث لا يعول عليه”.





