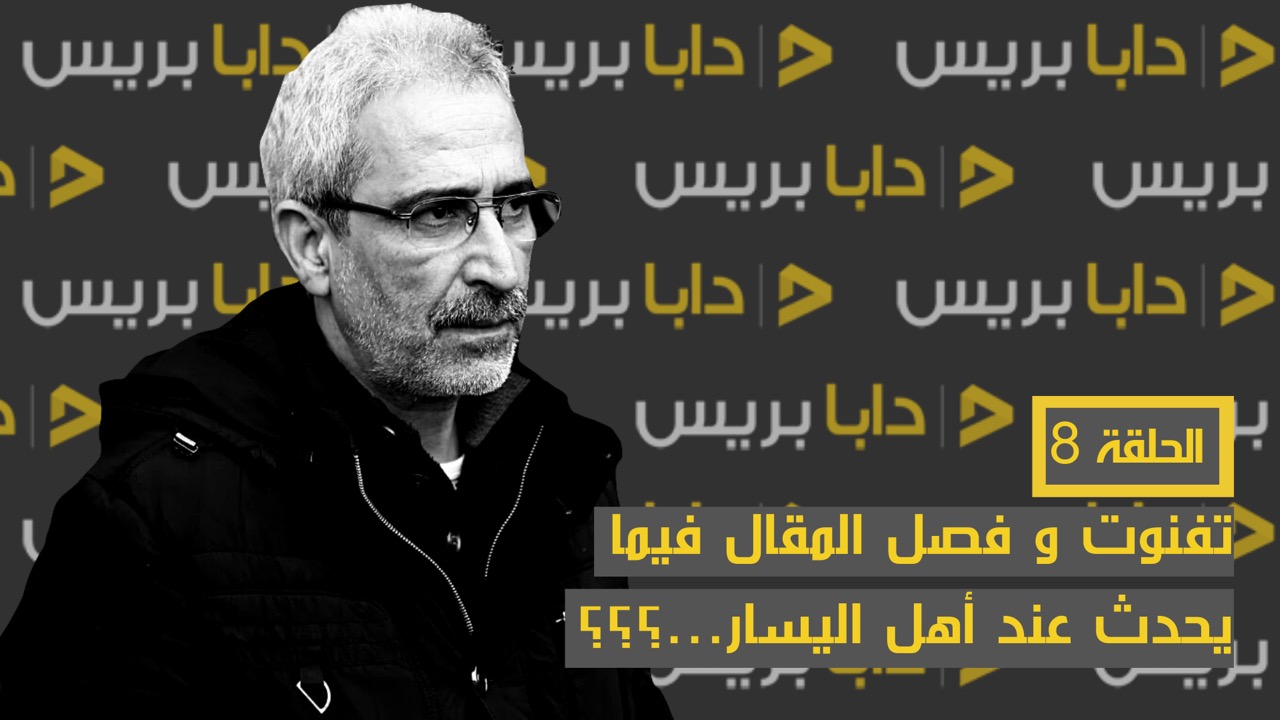
انتهينا في الحلقة الماضية ونحن نقف عند قضية حساسة ولها موقع هام في سلوكيات المدرسة اليسارية بجل منابعها، وهي قضية النقد السياسي الموضوعي والذاتي على السواء، وشجاعة مايترتب على ذلك من تحديد فصيح للمسؤوليات، وتسمية أطرافها سواء في حالة الفشل والنكسات، أو في حالة كسب النجاحات وتحقيق الصعود…
وهذا ماحاولت أن ألتزم به منهجيا وأنا أعيد جزئيا استدعاء الخطوط العريضة لمرحلة ” فصل الربيع ” المغربي وهي مطروحة على جدول المؤتمر الثالث للحزب الإشتراكي الموحد، بقضاياها العملية والنظرية، وعلى رأسها قضية “العجز الجمعي الوطني” على صياغة توافق منتج متفاوض عليه بالإرادة العاقلة والنظر البعيد لبناء مشروع الدولة الديمقراطية المستقرة على خيارات العقل الدولتي المستقل، بأدوات مؤسساتية تقوم على السيادة العامة للشعب، ولأولويات الإنسجام الوطني، الذي يعادل مفعوله قوة الطاقة الكهربائية العالية القيمة في مشروع انبعاث الفنيق المغربي من رماده..

وفي هذا الباب لم أجد أدنى تردد ذهني وأنا أحدد سلم المسؤوليات في حصول هذا العجز، بتحميل التكلفة الأساسية فيه للدولة بقيادة المؤسسة الملكية وكل القوى المباركة لتدبيرها العام للسياسات الرسمية… لكن دون إسدال الستار على مسؤوليات كبرى لجموع القوى ذات المنشأ النضالي للحركة الوطنية وجيش التحرير والحركات النقابية ومؤسسات إنتاج الفكر السياسي اليساري المعارض للأطروحات الرسمية في حقل تدبير الدولة ألاقتصادي والسياسي والإيديولوجي..
.
من المؤكد أنه سيوجد من القراء والمهتمين بتغيرات الحياة السياسية بالمغرب، من سيواجهنا بالسؤال القلق والصعب الذي يستنكر تشخيصنا هذا، ويعتبره خطابا للمزايدة وللتشبث ببقايا مواقف راديكالية أو عدمية، !!!تخفي نزعتها الجمهورية أو اللاملكية !!!، و تمحي بجرة قلم كل الخطوات المتقدمة التي أقدمت عليها المؤسسة الملكية،وهي تضغط على ” نفسها ” في معادلة غير مستوية الأضلاع والقوة، لتتجاوب مع حزمة من المطالب السياسية والحقوقية بل والدستورية التي كانت مضمون نزاع شرس بين المؤسسة الملكية، منذ مطلع الستينيات، وبين حلفاءها الوطنيين القدامى الذين أصبح جزء كبير وحيوي منهم معارضا لها!!!!!…
– لقد قيلت لي العديد من شبيه هذه التحفظات القلقة، وبطرق متفاوتة الحدة، ومن جهات مختلفة،ومن شخصيات ليست كلها بالضرورة تنهل من نفس المقاربات السياسية والإعتبارية..
– وبالنظر إلى أهمية بعض من محتوى هذه المؤاخذات ، اعتبرت أنه من الواجب علي،وبسرعة، أن أوضح كلامي هذا حول حجم مسؤولية المؤسسة الملكية في “ما لم تقدر أية صيغة من صيغ التوافق الوطني” أن تصل إليه على طريق تحرير الصفحات والعناوين الكبرى للمشروع المجتمعي المغربي الذي كان( وقد لايزال ) من شأنه أن يشكل المعادل الجديد لوثيقة الوحدة الوطنية وبناؤنا لدولتها الديمقراطية…
أشياء عن الجمهورية الفاضلة…
وكلام عن الملكية الواقعية…
 في مطلع التسعينيات، أي شهورا قليلة بعد إطلاق سراح العديد من المعتقلين السياسيين وبزوغ حالة بطيئة من الإنفراج السياسى الجزئي المحسوب طبعا، جمعتني الكثير من الجلسات مع رفاق قدامى من جيلي ومن الأجيال السابقة علينا، وفي أغلبهم أطر مهمة ومهمومة وأدت ثمنا فادحا من عمرها تبنيا وإيمانا بأراء وتصورات سياسية فكرية في مواجهة نظام اعتبروه نظاما ديكتاتوريا وقمعيا بل ورجعيا ومتحالفا مع أقطاب دول إمبريالية هي السبب فيما حل ببلداننا وشعوبها من محن وتدمير لسياداتها الوطنية …
في مطلع التسعينيات، أي شهورا قليلة بعد إطلاق سراح العديد من المعتقلين السياسيين وبزوغ حالة بطيئة من الإنفراج السياسى الجزئي المحسوب طبعا، جمعتني الكثير من الجلسات مع رفاق قدامى من جيلي ومن الأجيال السابقة علينا، وفي أغلبهم أطر مهمة ومهمومة وأدت ثمنا فادحا من عمرها تبنيا وإيمانا بأراء وتصورات سياسية فكرية في مواجهة نظام اعتبروه نظاما ديكتاتوريا وقمعيا بل ورجعيا ومتحالفا مع أقطاب دول إمبريالية هي السبب فيما حل ببلداننا وشعوبها من محن وتدمير لسياداتها الوطنية …
– وكانت أحاديث أغلب المناضلين( الذين كانوا يحملون كل منهم جروح جسده، وجروح تساؤلاته بعد المصائر القمعية التي ألمت به)، كلها منكبة وتركز على ثلاثة قضايا، واحدة إيديولوجية نظرية تصب أغلب مشاكلها في قضايا وأسئلة الإنتماء العقائدي المدرسي وانقاساماته، والثانية والثالثة من طبيعة سياسية، كان الخطاب التقدمي بمعتدليه وجذرييه يصنفهما في عداد ” القضايا المحظورة أو اللامسموح الكلام فيها “، وأقصد بذلك قضيتي ” الملكية، والوحدة الوطنية “…
– وبالقدر الذي كانت فيه هذه القضايا تكاد تهيمن على كل حوار منظم أو غيرمنظم بين مناضلي مختلف تيارات اليسار ، بالقدر الذي كنت ألاحظ فيه( مع مجموعة من الرفاق، طبعا، الذين كنت أحس بروابط الإقتراب معهم أكثر )أن هناك حواجز تكبل نظرة المناضلين في النظر لمسألة التعاطي مع موضوعتي الملكية كمنبع رئيسي للسلطة، والوحدة الوطنية كصيغة سوسيوسياسية لتجسيد وجود السلطة/ الدولة القائمة …
– وقد برزت حدة تلك العوائق الفكرية المنهجية جليا حين بادرت مجموعة من الرفاق( ستسمى بمجموعة ” المواطن” نسبة إلى إسم الجريدة التي ستحمل نفس الإسم ) إلى تقديم عرض سياسي لبناء الحزب الإشتراكي اليساري الكبير ، بنفس يساري نقدي ومتحرر من كوابح التبسيطية الفكرية في تناول قضايا السياسة ، وخلطها بما ليس له ارتباط بحقولها، أي السياسة المنتظمة على حسابات الاستراتيجية والتكتيك ومايستلزمه ذلك من تخطيط لمراكمة القوة وعناصر نجاح برامج التغيير من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية …
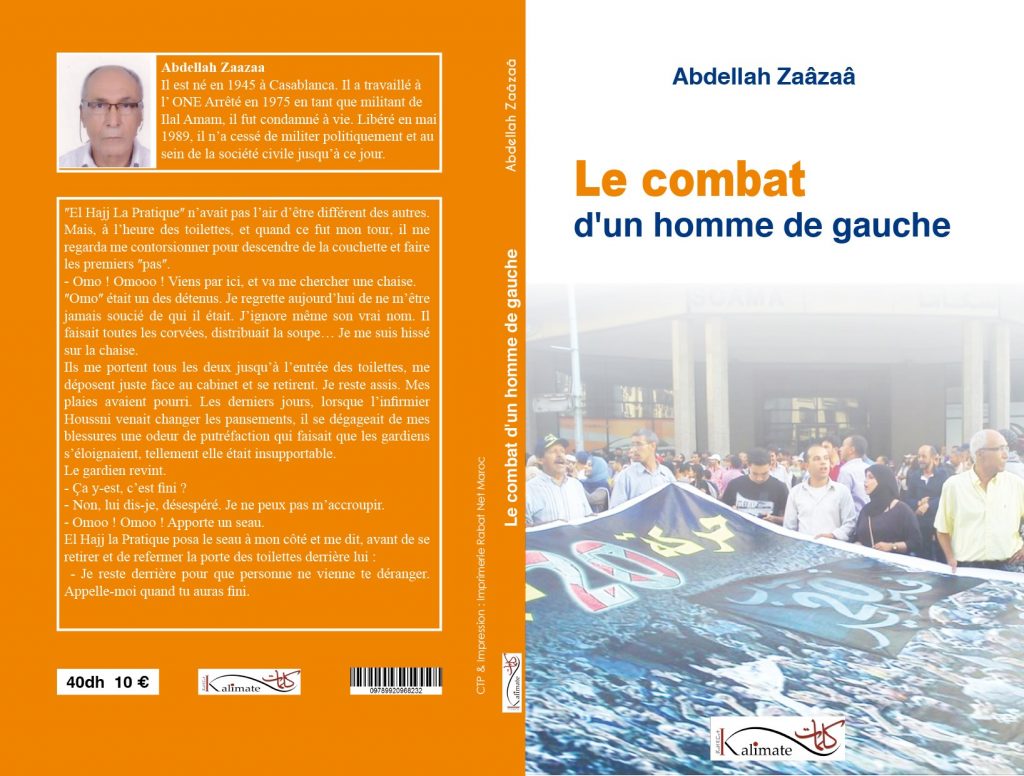
– و في تقديري كانت تلك مناسبة لاختبار مدى وضوح رؤى المناضلين في قضية الملكية كنظام للحكم، والمسألة الوطنية، التي كانت الدولةتساوي معناها العام منذ أواسط السبعينيات بالموقف من قضية الصحراء، والنزاع الجاري حولها على صعيد مؤسسات الأمم المتحدة..
– ولقد تبين لي أن الموقف من طبيعة الحكم وشكله لدى أغلب فصائل اليسار الجذري بقيت مشدودة لتلك الثنائية المثالية التي لايستقيم وجودها بوجود طرفيها في ذات الوقت : – فإما نظام ملكي أوتوقراطي فردي تسلطي ينهش عظم الكل وكل من يحاول أن يناضل من داخل مؤسساته سيحكم على نفسه بالضياع ،
– أو نظام جمهوري يجسد حكم الشعب لنفسه بنفسه وهو الأمر الذي يعني التحرر والحرية الجماعية…
وهذا ماكنا نقول أنه يضمر في طياته إلغاء مسبقا و” مبدئيا” لشئ إسمه إمكانية وجود طريق آخر قد نسميه ثالثا أو رابعا أو خامسا،يضع الفعل السياسي والتفكير السياسي في محك النسبية وجدلية الإحتمالات…
لقد كانت تصورات المناضلين ، وقتها ،لأي عمل سياسي ، بصريح العبارة أو بغموضها،محكومة بهذه القطبية النفسية الإيديولوجية،فإما أنك جمهوري الفكر تسعى للإنتصار لسلطة الطبقة والجماعة والأمة والشعب، أو أنك ملكي الإختيار وبالتالي ستجد نفسك منحازا، بقوة الأشياء، لنظام الفرد المطلق الناطق باسم السماء أو اللاهوت…وبالتالي فلا مجال لأي أمل في نجاح أية عملية للتغيير، أو بناء أداة نضالية لترجمة ذلك الطموح …
وهذا يعني أيضا الإنزلاق بفهم العمل السياسي إلى انغلاقية تكبح الحلم الواقعي وتحرم القوى اليسارية الثورية فعلا من إمكانات وإبداعات مناضلين هم موجودون أصلا في مواقع العملية التغييرية بمستوياتها المتفاوتة…بل لقد بلغ الأمر بالبعض من الرفاق أن عبر صراحة أن لاجدوى من لأي عمل سياسي في ظل الأوضاع التي تتحكم فيه ملكية مطلقة من كل المداخل، ماعدا الإكتفاء بالعمل في الساحة الجماهيرية ومراكمة مواقع التأزيم والتصعيد بدون إعلان سياسي واضح لهذا المنهج في العمل النضالي..
– من الواضح اليوم، أننا كنا كيساريين، ولازلنا، في موضوع العلاقة مع المؤسسة الملكية نعيد إنتاج ماتركته لنا أدبيات وممارسات مكونات الحركة الوطنية المغربية بتعدد عائلاتها السلفية واللبيرالية الإجتماعية والشيوعية والإشتراكية، وهي أدبيات وممارسات نعثر فيها على صورتين مفارقتين لعلاقة تتوالى فيها أحاسيس الحب والولاء، الأحاسيس النفور والقطيعة…فبعد المواجهة مع المستعمر بعنوان التحالف بين السلطان والحركة الوطنية، والنجاح جزئيا في التفاوض على استقلال غير مكتمل بواسطة هذا التقارب المشترك، ،
انطلقت مرحلة مابعد الإستقلال لتنطلق مسارات نزاعية مع المؤسسة السلطانية حول مشروع المغرب الجديد الذي ستتوسع فيه القطائع، وستتبدل فيه التحالفات، وستتغير فيه الخرائط السياسية والطبقية الإقتصادية…ليتشكل، وبتوالي السنوات المستعرة، على يسار الملكية ومن انحاز إليها كثلة عريضة من التيارات( الأجنحة السياسية، مناضلو جيش التحرير والمقاومة، والحركة النقابية ) المعارضة لتدبير شؤون الدولة والمجتمع…

– لقد كان لهذا الإرث من التقلبات، والصراعات بجميع الوسائل التي خاضها هذا “الشعب” اليساري الوطني بجل اختلاطاته، أثرأ كبيرا على باقي الأجيال التي ستباشر “وصايا” الإستمرار ومهام البقاء، بما فيها تأثرهم نظريا وعمليا على تصورهم ونظرتهم للمؤسسة الملكية في تغيراتها السابقة واللاحقة…فإما هي عدو مطلق، أو إما صديق لايفارق، حليف الشرعية التاريخية ورفيق التحرير، وبعد ذلك المتسلط الذي لايستمع إلا لنفسه وحلفائه الرأسماليين العالميين…
وعلى العموم يمكن القول إن هذه التمثلات التي شكلها العقل الوطني، وضمنه العقل اليساري، عن نظام الملكية منذ ماقبل الأستقلال مرورا بمراحل الصراع حول السلطة بعد معاهدات الجلاء، لم تسمح له ذهنيا ومعرفيا في بلورة تصور استراتيجي للعلاقة مع هذه المؤسسة المركزية والممتدة في حياته السياسية التاريخية حتى قبل أن تأتي فترة الحماية الغربية لتقلب تلك الحياة رأسا عن عقب…
وهو ماتثبته جل الوثائق السياسية للعائلات الوطنية المتوالية عبر عقود، حيث لانجد فيها خيارا سياسيا استراتيجيا واضحا بالإسم والمسمى يكشف لنا ما الشكل والموقع الذي ستحتله مؤسسة سلطانية، لها رمزية يختلط فيها المورد الديني بالمورد السلطوي ، في مغرب يخرج لتوه من زمن الوصاية الإستعمارية باسم المهمة الحضارية وقيم التحديث؟؟؟
هل ستكون سلطة روحية رمزية تشكل مايسميه ” غرامشي ” في حديثه عن الإيديولوجيا الثقافية بإسمنت البنية الوطنية، دون أن يتحول دورها إلى صرح أكبر من الدولة،؟؟
أم ستكون الحليف التاريخي والطبقي الحديث في معركة التقدم والخروج من التأخر وبراثنه؟ أم ستكون خصما فكريا واقتصاديا نتوافق معه على خريطة طريق يعاد فيها بناء جديد للدولة الوطنية المغربية الحديثة كدولة ناهضة اقتصاديا وسياسيا وطنيا وإقليميا ودوليا؟؟؟
كيف الوصول إلى صياغة تعامل مبني على قواعد السياسة الواقعية لكتابة العقد البرنامجي الوطني تكون فيه المؤسسة الملكية وكل مكونات الوطن الذي ناضل من أجل الحرية أطراف في إنجاح بنوده على قاعدة التسوية الديمقراطية دون التغاضي عن نوعيات العوائق الموضوعية والذاتية للبلاد؟؟؟
إن عدم السير في هذا المنحى الأكثر ارتباطا بأحكام عقل التقدم تركنا إلى اليوم كنخب مغربية بمختلف مدارسها في وضع غير استراتيجي متحرر من مسبقات العوامل القديمة( اللاسياسية ) في التعاطي الجوهري وحتى الشكلي مع الملكية، كسلطة مركزية تختزن في ميزان قوتها كل صلاحيات قيادة الدولة المغربية..
فهل كان بالإمكان غير هذا الذي حدث، وهل لعب اليسار دوره في توضيح هذه العلاقة مع مؤسسة الملك التي وصفتها بأنها محورية في إنتاج سياسة الحكم بحكم وزنها المتزايد في مقابل التراجع الذي تعيشه المؤسسات المضادة..
هذا ماسنعود للخوض فيه في الحلقة القادمة …




